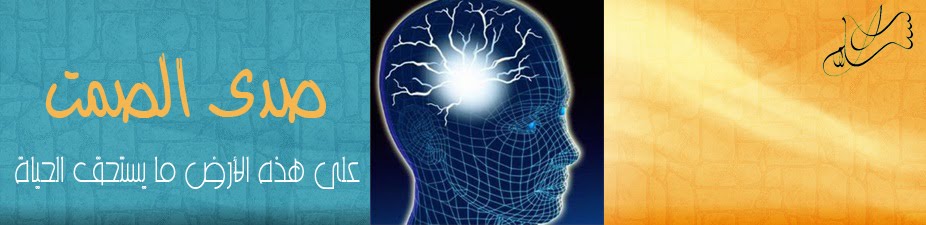عرف منير كيف يتفادى المواقف المحرجة، فإذا ابتسم له شخص ما، أو صافحه
بحرارة عرف أنه صديق قديم، وربما كان عزيزا جدا؛ يُظهر له إسوارة تحيط بمعصمه
مكتوب عليها "يعاني من إلزهايمر".. استحسن الفكرة، وراح يطبقها مع كل
شخص ثرثار، أو إذا أراد تجنب جدال عقيم، أو للتهرب من الدائنين ومن يراهم ثقال
الظل..
تخيل يا أستاذ خليل يوم أمس اتصلت على الجريدة، ردت عليّ السكرتيرة ولم
تعرف صوتي، قلت لها حوليني إلى رئيس التحرير، قالت إنه في اجتماع، وبعد الإلحاح
قالت لي بغضب: أرجوك للمرة العاشرة أطلب منك ألا تتصل معنا!! شو اللي بصير؟ لماذا
ينكروني؟ ويتهربون من مكالماتي! لماذا لم تعد الجريدة تنشر قصائدي ومقالاتي؟
كدت أن أصارحه بأنه لم يعد ذلك الشاعر المبهر، وأن قصائده لم تعد مفهومة،
ومقالاته عبارة عن شطحات فكرية منفصلة عن الواقع، وأنّ النقاد بعد أن قرعوه مرارا
وتكرارا صاروا يتجاهلونه.. لكني خشيت من ردة فعله، ولم أرغب بنكء جراحه، أو خدش
مشاعره، فآثرت الصمت.
تأمل منير في الصورة المثبتة على صدر الصالون، وقد أدرك أنها صورته، أخرج
من الدرج ألبوم صور قديم، لاحظ أن نفس الصور تتكرر، وأن شخصاً ما يظهر في أغلبها، على
الأرجح هو أنا، قال في نفسه.. حدق في المرآة فرأى شخصا مختلفاً؛ شخصٌ هده التعب،
وبان عليه الهرم، عيناه غائرتان، وجهه حزين وعابس، تحسّسَ براحتيه وجنتيه اللتان
برزتا كنتوء عظمي، وتأمل حاجبيه الكثيفين وثم أمسك بلحيته البيضاء الكثة، عاد
للوراء متراً فذُهل من جسده الهزيل وقد بدا كمن نجا من مجاعة، عاد للألبوم من
جديد، الشخص الذي يظهر في تلك الصور وسيم، ممتلئ الوجه، حليق اللحية والشوارب، نضر
البشرة تبدو عليه علامات الصحة والهيبة، مبتسم دائما.. لا يكفي أني نسيت اسمي،
نسيتُ حتى ملامح وجهي! قال مخاطبا نفسه بتحسر.
سار طويلا في شوراع المدينة وطرقاتها الفرعية حتى أضناه التعب، كان كل ما
يحتاجه معرفة عنوان سكنه، فقد تعب من المشي ومن السؤال، صار همه الوحيد أن يعود
لبيته، ليتناول وجبة شهية، وحمّاما ساخنا، ثم ينام.
في موعد لا يخطؤه، صعد في قطار الثامنة صباحاً، وجلس قرب النافذة، وراح
يراقب الشوارع والأشجار والناس والسيارات، بينما القطار يتحرك وعجلاته تدور
بانتظام مصدرة صوتا موسيقيا متكررا ينسل إلى خلاياه، تذكر كيف كانت الأيام الخوالي، أماكن كثيرة كانت شاهدة
على قصته التي تتكرر بشكل شبه يومي.. والتي طالما سردها على مسمعي دون كلل، ودون
أن ينسى كلمة واحدة.. كان يطمح أن يستحوذ على المدينة بأكملها، اعتقد أنه يستطيع
تحريك كل شيء بأصابعه، وأنه سيصلح نظام الكون الظالم، وسيعيد الحق لأصحابه..
زرته ذات مساء، استقبلني بفتور، ثم انزوى إلى كنبة في زاوية الصالون، أشار
إلى الحائط وقال بحماسة: تلك صورة زوجتي، ثم صمت للحظات وأضاف: ينتابني حيالها
شعور غامض، شعور يغمره الحنين والحب والأسى. ثم أشار إلى صورة أخرى كانت في إطار
خشبي بجانب التلفزيون وقال بصوت حزين: وهؤلاء هم أولادي، وأخذ يشير إلى بقية الصور
المصفوفة فوق الكوميدينة وهو يقول بحيرة: صور كثيرة لأشخاص أدرك في أعماق نفسي أني
أعرفهم، وأني مشتاق لهم... لكن أين هم الآن؟ لماذا لا يزورونني؟ لماذا تركوني
وحيدا؟ هل اقترفت جرما بحقهم حتى نبذوني؟ أم أنها مجرد صور متخيلة لأناس لا
أعرفهم، وأنا من الأساس وحيد وبلا زوجة ولا أهل؟ كنت صامتا ومصدوما بأسئلته، ثم
قال بصوت خافت وبنبرة استفهام: هل هذا هو بيتي حقاً؟ أم أني دخلت بيت أحدهم
بالخطأ؟
كنتُ سأقول له (وربما قلت لا أذكر) إن القطار الذي طالما تغنى به، توقف منذ
زمن بعيد.. القطار الآتي من غزة، مرورا بقرية بتير هناك حيث تخترق سكة الحديد الوادي
القابع بين جبلين تغطيهما غابات الصنوبر، وصولا إلى القدس، ثم صعودا إلى حيفا
ويافا.. ذلك القطار توقف منذ النكبة التي حلت بالبلاد، بل إن البلاد ذاتها ضاعت،
ولم يعد منها سوى ذكريات منير وقصصه الجميلة والمثيرة.. وأغلبها مختلق ومتخيل.. أظن
أني حينها التزمت الصمت، واكتفيت بهز رأسي إعجابا واحتراما لذكرياته الحميمة..
في نهاية ذلك اللقاء، وكان الأخير بيننا، ابتسم بفرح مصطنع، وربما بسخرية، وراح
يغني وهو يحرك يديه مثل قائد أوركسترا: لسه فاكر كان زمان.. كان زمان ..
أكثر من عانى منه زوجته أحلام، تحملته بصبر المؤمنين ويقين العشاق، ولطالما
تشاجرت معه بسبب غيابه المتكرر والطويل عن البيت، خاصة وأن تبريراته لم تكن مقنعة،
وجميع قصصه مفككة.. لكنها كانت تحس بصدق كلامه رغم تناقضاته الواضحة، هكذا مجرد
إحساس؛ بيد أن أبنائه الذين انشغلوا به كثيرا في بدايات الأمر، ثم بدأوا يتعودون،
وصل بهم الأمر حد عدم الاكتراث.. بقية معارفه كانوا يتناقلون عنه قصصا غريبة
وبتحليلات متعددة؛ قالوا إنه يعاني من فقدان الذاكرة القريبة، وآخرون قالوا إنه
يعاني من إلزهايمر، وغيرهم قال إنه يعاني من انفصام الشخصية، وبعضهم أكد أن حالته
تسمى اضطراب الهوية المزمن، أو تعدد الشخصيات المركّب، أما ابن عمه قيس فقال إنه
يعيش حالة توهم ويتخيل الأشياء والأحداث من حوله، بما يشبه الهلوسة، فيما أكد جاره
حسين الذين طالما تناقش معه في أمور كثيرة أنه لا يعاني من أي مرض نفسي أو ذهني،
هو مجرد فيلسوف حر يحاول التنكر من كل شيء، بما في ذلك تنكره لنفسه، حتى أنه يرفض
حمل هويته في جيبه، ولا حتى في عقله..
بعد إلحاح من زوجته وأولاده وافق على زيارة طبيب نفسي مشهور، في البداية
كان متكتما ومتحفظا، ولكنه بدءا من الجلسة الثانية صار شخصا آخر، انطلق لسانه،
وصار يسرد القصة تلو الأخرى، ويسترسل في الشرح، ويشرّق ويغرّب، وأحيانا يهذي
بكلمات غير مفهومة، وبصوت متحشرج كما لو أنه أتٍ من غياهب كابوس، يبكي بحرقة
أحيانا، ثم يضحك بأعلى صوته.. تحير الدكتور فضل في تشخيص حالته، وفي أكثر من مرة
كان يحس أنه مجرد إنسان يعاني الوحدة، وكل ما يريده مجرد الحديث، يريد شخصاً ما
يسمعه، وهو مستعد لدفع كل المبالغ الممكنة لقاء كسر وحدته، والخروج من عزلته..
وأحيانا يقتنع بأنه لا يعاني من أي اضطراب معروف، وأنه شخص مثقف ويتلاعب بطبيبه..
لاحظ الطبيب أنه يستعين بعضلات بطنه في استخراج تلك الأصوات الغريبة، وكأنه
يحاول تقيء شيئ ما لا يعرف ما هو.. ربما هو الأسف والندم.. ربما يحاول رد إهانة
مؤذية تعرض لها في مطلع شبابه، أو يحاول مداواة جرح غائر، كان مثل العاشقة المخدوعة
التي عجزت عن الانتقام، واستسلمت.
ذات مساء، اجتمع عدد كبير من أصدقائه في سهرة
نهاية الأسبوع بدعوة من خليل وفي منزله، الذي فاجأهم بإلقاء كومة أوراق على
الطاولة، قال إن حفيد منير عثر عليها بالصدفة، بعضها وجدها في جيبه، وبعضها كانت
في درج مكتبه.. على الفور تلقفوها، وكلما قرأ أحدهم قصاصة ظهرت على وجهه علامات
الاستغراب والدهشة، فيمررها للآخر، والذي بدوره يندهش أكثر..
"أنا الآن في لحظة استفاقة، تنتابني مثل هذه اللحظات من حين إلى آخر،
لا أعرف كيف تأتي، ولا متى تنتهي، يتيقط عقلي فجأة، وأستعيد جزءا من ذاكرة بعيدة،
المهم أن أستغل اللحظة فأسارع لتدوين ملاحظاتي؛ أعرف أن اسمي منير، وأنني من قرية
بيت نتيف قضاء القدس، وأني في الستينيات من عمري.. عدا ذلك لا أعرف شيئا، لكنّ في
جيبي ورقة عليها جميع بياناتي: ديانتي، جنسيتي، تاريخ ميلادي، رقم الهوية، عنوان
السكن، المهنة، الأرقام السرية لحسابي المصرفي وبطاقة الصراف الآلي، والباسوورد
لبريدي الإلكتروني، ولصفحتي على فيسبوك وحساب الواتس أب، ورقم هاتفي الخلوي.. في
الحقيقة لا أعرف ماذا تعني لي هذه البيانات، ولا مدى أهميتها.. بل إني أشعر أنها
عبء عليّ، وأني سعيد بالتحرر منها.. لن أُخرج تلك الورقة التافهة، سأجرب أن أعيش
بدونها".
"ما قيمة كل هذه المحددات اللعينة؟ هي مجرد قيود.. وأنا الآن بلا
قيود، بوسعي الانطلاق في أي اتجاه، والركض بلا توقف، وبلا هدف، أشعر أني خفيف
وأكاد أطير، وسعيد مثل عصفور استفاق للتو صبيحة يوم ربيعي، وإني على وشك الضحك دون
سبب، ومستعد لقبول أي فكرة وتبني أية هوية، ولكن ما أهمية الهوية أو الفكرة نفسها،
حتى لو تبنيتها أو اقتنعت بها، سأنسى كل شيء، وسأبدأ من جديد.."
"أنا شخص آخر، ربما يكون عدد شخصياتي بعدد سنوات عمري.. هل هذه علامة
حكمة ونضوج؟ أم هو مرض ذهني؟".
"أعرف بل ومتأكد أن لي زوجة محبة ووفية، وأبناء وأهل وأقارب وأصدقاء
ومعارف وجيران، ومن المفترض أني أحبهم ويحبوني.. ربما لي ابنة مقربة ربيتها على
مهل، وانتظرتُ على أحر من الجمر حفلة تخرجها من الجامعة، وربما لي ابن يحتاجني
الآن.. لا أتذكرهم، لو رأيتهم لن أعرفهم، أنا حتى لا أعرف من أنا، أحتاج أن أستخرج
ورقة من جيبي لأقرأ اسمي.. كم أنا حزين.. وما يفطر قلبي أني فقدت كل ذكرياتي.. شطبتها
متعمدا.. أنا تائه، وبائس".
قبل يومين، عاد مبكرا، كانت الشمس تهم بإقفال نهار حار، دخل البيت بخطوات
سريعة وواثقة، واتجه على الفور إلى الصالون، لبرهة شعر وكأنه يدخل منزلا جديدا،
غرفة الجلوس جميلة ونظيفة، كنبات وثيرة مخملية اللون، وثمة قطة لطيفة نائمة على
إحداها، وعلى الحائط لوحة زيتية لسيدة حزينة، ثُبتت محل صورته، لم يغضب ولم يستغرب
حتى، لم يكن في البيت سوى حفيده من ابنته، فنادى عليه:
- تعال يا فريد.. واحضر لي معك كوب ماء بارد.. ريقي ناشف.
- نعم يا جدي، تفضل..
- أين أمك؟
لم يجب فريد، وحاول إداره وجهه..
- طيب أين جدتك
أحلام؟ مضى وقت طويل ولم أرها!!
لم يجب فريد، وتصنع انشغاله بالنظر إلى المطبخ، ثم اتجه نحو الثلاجة وأعاد
إغلاق بابها من جديد.
- يا ابني لماذا لا ترد! هل أصبت بالطرش فجأة؟
- لا يا جدي، لكنها المرة العشرين وأنت تسألني الأسئلة
نفسها منذ الصباح!
- كيف يعني المرة العشرين! ومنذ الصباح! وأنا للتو دخلت
المنزل، فمنذ الصباح وأنا أتجول في شوارع المدينة!
- يا جدي، أنت
لم تغادر فراشك منذ سنتين. وقبل ذلك كل قصصك عن القطارات، ومحطة القطارات،
والمترو.. هذه ربما رأيتها في أحد الأفلام، لأنه لا يوجد في كل بلدنا قطار واحد..
أصلاً لا توجد سكة حديد..
صُعق منير، وارتسمت على وجه أكبر علامة استغراب في حياته، وقد بدا مندهشا
وغير مصدق.. وكأنه تلقى للتو خبرا فاجعا.. لكن الخبر الصاعق سيأتيه الآن:
- وأحب أن أذكرك
أن جدتي، والتي هي زوجتك توفيت قبل أن أولد، يعني قبل عشر سنوات على الأقل..
بكسل طالبٍ سيقدّم امتحانا بعد ساعة وقد يئس من إمكانية نجاحه، تردد في
النزول من سريره.. نظر من النافذة، كانت أضواء الشوارع ما تزال مشتعلة وثمة غيوم
تحوم في سماء المدينة وتنذر بزخات من مطرٍ خفيف لعله يغسل ما خلفه ليل طويل.. أغلق
النافذة بعد أن سرت في بدنه قشعريرة برد الصباح، عاد إلى فراشه منسلا مثل عاشق
مخذول، كانت كومة الأدوية مكانها على المنضدة، وبجوارها كأس ماء نصف ممتلئ، ومنفضة
تكدست فيها عشرات أقماع السجائر.. تهيأ له أن في خلفية المشهد تُعزف موسيقى
تصويرية حزينة.
نادى على زوجته بصوت مشوب بالرجاء: يا أحلام.. يا أحلام.. ثم على أبنائه:
يا منى، يا سامر.. يا فريد.. ثم على الجيران.. لم يرد أحد.. لم يسمع سوى رجع
الصدى.. أين ذهب الجميع؟ لماذا يختفون فجأة حين أحتاجهم؟ تساءل بحيرة وقلق.. راحت
تلك الموسيقى الحزينة، وساد محلها صمت ثقيل.. يتخلله صفير رياح تنفذ من طرف
الشباك.. طال انتظاره وهو يحدق في سقف الغرفة حينا، وفي النافذة حينا، حتى فُتح
الباب بهدوء، التفت نحوه بترقب ولهفة من ينتظر الحافلة، فإذا بأحلام تدخل بكامل
زينتها، كانت ترتدي فستانا من الساتان الشفاف بلون المشمش، شعرها الكستنائي منسدل
على كتفيها وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة غامضة.. رفعت طرف البطانية وانسلت بجانبه
بهدوء، بحنيّة وحنان وافر فردت ذراعها الأيمن فوق صدره، فاحتضنها على الفور بكل
قوته.. لم ينبسا بحرف، كان يهم بمعاتبتها، والبوح لها بأشواقه وحنينه وخوفه.. لكنه
آثر الصمت والاستسلام لبهاء اللحظة، وتقديرا لحميمتها.. وشيئا فشيئا أخذت حرارة
جسديهما تخفت، أغمضا عينيهما ببطء لذيذ، وراحا في سبات عميق..